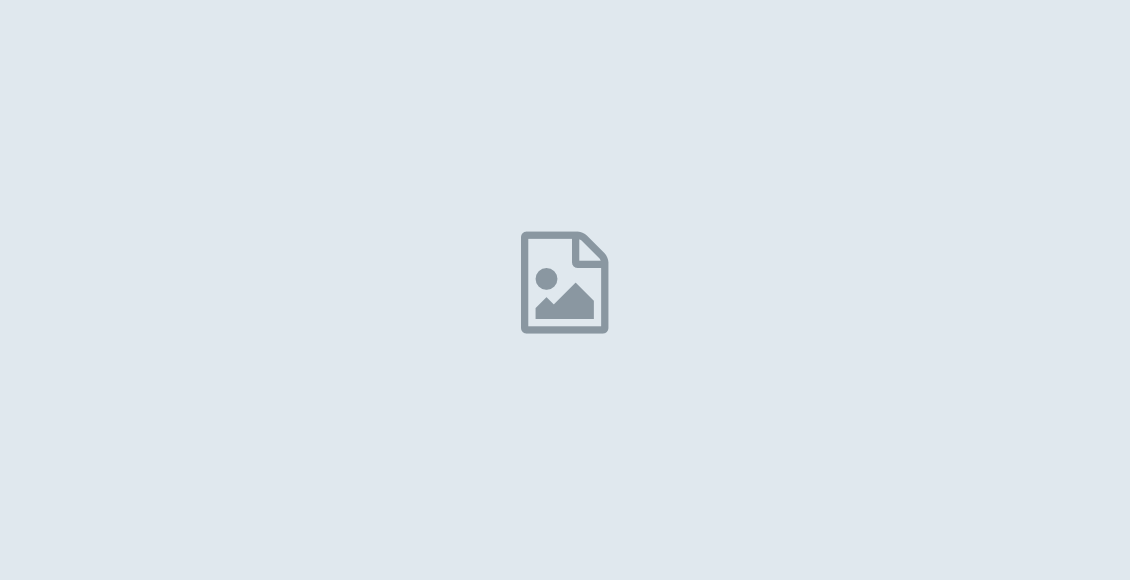أهمية استغلال الفرص
كما جرت العادة، نستهل الجلسة الأولى من درس الأصول في العام الدراسي الحالي بكلام نوراني من أهل البيت عليهم السلام، لنستفيد من بركات هذه الكلمات النورانية، ولتكتسب هذه الجلسة نورانية من خلال نقل أقوال المعصومين عليهم السلام، فتتهيأ قلوبنا وأرواحنا لتلقي العلوم والمعارف الإلهية ومقدماتها وأدواتها.
في رواية نقلت في بحار الأنوار، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
«ما يُساوى ما مَضى مِن دُنياكُم هذهِ بأهدابِ بُردِي هذا، و لَما بَقِيَ مِنها أشبَهُ بما مَضى مِن الماءِ بالماءِ، و كُلٌّ إلى بَقاءٍ وَشِيكٍ و زَوالٍ قَريبٍ، فبادِرُوا العَمَلَ و أنتُم في مَهْلِ الأنفاسِ، و جِدَّةِ الأحلاسِ قبلَ أن تُؤخَذوا بِالكَظَمِ»
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «والله، إن ما مضى من دنياكم هذه لا يساوي أهداب بردي هذا، وما بقي منها أشبه بما مضى كما يشبه الماء الماء.»
كم يتشابه الماء مع الماء؟ الماء العادي، وليس الماء الذي أصابه شيء؛ كم يتشابه الماء مع الماء؟ بنفس القدر، فإن ما تبقى من دنياكم يشبه ما مضى منها.
وكُلٌّ إلى بَقاءٍ وَشِيكٍ و زَوالٍ قَريبٍ: الكل يبقى قليلاً ويزول قريبًا. يقول: إنه يزول قريبًا، أي أن الجميع سيزولون قريبًا.
نظن أننا ما زلنا بعيدين جدًا عن الرحيل من هذه الدنيا، ونرى أن وقت الموت ما زال بعيدًا عنا. جميعنا هكذا. نقبل بمبدأ الرحيل من هذه الدنيا، نؤمن بالموت، نعلم أننا جميعًا سنغادر هذه الدنيا يومًا ما، لكننا نرى توقيت حدوثه بعيدًا جدًا. نقبل بالمبدأ، لكننا جميعًا نرى توقيته بعيدًا عنا. نعتقد أن الأجل سيأتي إلى الجميع ثم يأتي إلينا؛ بينما بعد دقيقة واحدة، بعد ثانية واحدة، لا نعلم ماذا سيحدث.
يصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا أولاً ويقول: ما مضى وما بقي متشابهان جدًا. يقول إن ما مضى لا يساوي أهداب هذا البرد، أي أنه قليل جدًا. وما بقي أيضًا قليل جدًا. لا تعتقدوا أن لدينا وقتًا كثيرًا، فرصًا كثيرة.
«فبادِرُوا العَمَلَ و أنتُم في مَهْلِ الأنفاسِ، و جِدَّةِ الأحلاسِ قبلَ أن تُؤخَذوا بِالكَظَمِ»
فما دمتم في فرصة الحياة، وفرصة التنفس، وبينما النماد (الأحلاس) ما زالت جديدة، وقبل أن تُؤخذوا بالكظم (أي الموت)، فسارعوا إلى العمل. إذا كانت النماد جديدة، فما الفرق بينها وبين القديمة؟ يضعون شيئًا كالنمد تحت سرج الجمل أو الحصان ليستقر السرج ولا يؤذي ظهر الحيوان. بعد فترة من الاستخدام، تتساقط أوبار النمد، تصبح صلبة، ويحين وقت استبدالها. يقول: قبل أن تصلوا إلى تلك المرحلة، بينما النمد (الذي يُسمى “آگند”، وهو النمد أو السجادة التي توضع تحت سرج الجمل) ما زال جديدًا، فالفرصة متاحة، وقبل أن تُؤخذ أنفاسكم، أي يأتي الموت، سارعوا إلى العمل. فالموت يخرج الروح من الإنسان، ويصبح التنفس مستحيلاً، وتنتهي الحياة. يقول: قبل أن تصلوا إلى هناك، «فبادِرُوا العَمَلَ». عندما تصلون إلى تلك المرحلة، لن يمكن فعل شيء.
هذا في الحقيقة تأكيد على استغلال الفرص والاستفادة القصوى منها للعمل؛ لأنه عندما يصل الإنسان إلى تلك النقطة، لن يكون بإمكانه فعل شيء، ولن يُضاف إلى رصيده شيء.
في الجلسة الدراسية السابقة، ذكرت أن ما أُوصينا به هو العلم النافع؛ العلم الذي يفيد الإنسان ويُظهر له صلاح وفساد قلبه، في مقابل العلم الضار أو العلم الخنثى. ألزم وأشرف العلوم والمعارف هي تلك التي تُظهر للإنسان هذا الطريق؛ تُظهر صلاح وفساد القلب. إذا كان الاختيار بين أن يتعلم الإنسان علمًا متعلقًا بصلاح وفساد القلب والروح أو غيره، فهذا بلا شك ألزم. هذا لا يعني أن سائر العلوم بلا قيمة؛ بعض العلوم الأخرى واجبة حتى، وواجبة كفائية، لكن إذا تجاوزنا الضرورة، فهذه العلوم هي الأشرف، الأكثر استحقاقًا للمدح، والألزم.
كم لدينا من الوقت؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما مضى من عمركم قليل جدًا، وما بقي منه قليل جدًا، تمامًا كتشابه الماء بالماء. تخيلوا ماءً، وما مضى هو ماء؛ كم يتشابهان! العمر الذي مضى والعمر الباقي مثل ذلك تمامًا؛ لا شيء يتغير. لا تعتقدوا أن في العمر الباقي، على سبيل المثال، وقتًا أطول؛ لا تعتقدوا أنه يسير ببطء أكثر؛ لا تعتقدوا أن شيئًا خاصًا سيحدث يجعلنا نحصل فجأة على كل ما يجب أن نكتسبه. إنه نفس الشيء. اكتساب العلم النافع، والمعارف المفيدة التي تُظهر لنا صلاح وفساد قلبنا، ممكن فقط من خلال استغلال فرصنا.
إذا عرف الإنسان قيمة الفرص، يمكنه أن يصل إلى هذه المعارف بقدر أكبر. هناك العديد من الروايات التي تؤكد على ضرورة استغلال الفرص، وأن فقدان الفرصة هو حزن لا يمكن تعويضه. هذا لا يتعلق فقط بالعلم النافع، بل بكل العلوم، بل بكل عمل.
في كلام من الإمام المتقين، أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: «بادِرُ بِالفُرصَةِ قَبلَ أَن تَكونَ غُصَّةً»؛ اغتنم الفرصة قبل أن تصبح سببًا للحزن والأسى. أي أن فقدانها يجعل الإنسان حزينًا. كم من الفرص كانت لكل واحد منا، وكان بإمكاننا استغلال هذه الفرص الذهبية للتقدم. هل كان الذين كانوا مؤثرين ومفيدين لأنفسهم وللمجتمع أشخاصًا مميزين أو لديهم إمكانيات خاصة؟ العديد من النجاحات، حتى من أصحاب المواهب المتوسطة، تحققت نتيجة استغلال الفرص. الموهبة، مهما كانت عالية، إذا لم تعرف قيمة الفرص، فمن الطبيعي ألا تصل إلى الهدف.
لذا، إذا أردتُ في بداية العام الدراسي أن أقدم توصيتين، أو بالأحرى تأكيدًا وتوصية؛ تذكيرًا وتوصية من لسان المعصومين، لطالبي العلم الإلهي، فهما في جملتين مستخلصتين من هاتين الروايتين، واحدة من الإمام الكاظم عليه السلام التي نقلتها في درس الفقه، والأخرى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
أولاً، أؤكد على أهمية هذا المسار والبيئة التي وفقنا الله لها؛ وهي بيئة تحصيل العلم النافع، العلم الذي يُظهر لنا صلاح وفساد القلب. قلت إن البيئة توفر الإمكانية، وليس أن كل من اكتسب هذا العلم وتعلمه قد وصل بالكامل إلى الهدف.
ثانيًا، استغلال الفرص والوقت؛ فكلما عرف الإنسان من المعارف الإلهية أكثر، أدرك عمق صلاح وفساد نفسه أكثر، وأصبح تحركه أكثر انضباطًا ونظامًا، وهذا في الحقيقة يؤدي إلى رفعة الإنسان ومكانته في هرم الوجود. قد لا يكون لشخص في الدنيا، ظاهريًا، مكانة أو شهرة أو سمعة، لكن هذه الدنيا من بدايتها إلى نهايتها ليست شيئًا؛ المهم هو في الدار الأبدية، حيث الحياة الخالدة، أي مكانة ومرتبة يحصل عليها الإنسان. تلك المكانة هي نتاج تحصيل العلم النافع واستغلال الفرص. «بَادِرُوا الْعَمَلَ»؛ سارعوا إلى العمل، وقبل أن يأتي الندم ولم يعد ممكنًا اكتساب هذه الأمور، يجب أن نجهز أنفسنا إن شاء الله.
الأصول العملية
منذ بداية مناقشة الأصول التي بدأناها قبل سنوات، وصلنا إلى مبحث الحجج، وذكرنا الأمارات واحدة تلو الأخرى: الظنون، والظواهر، والخبر الواحد، وبناء العقلاء. انتهى بحث الأمارات، لكن بحث الأصول العملية بقي.
الأصول العملية هي أيضًا من الحجج، لكنها تختلف عن الأمارات. إذا تذكرتم، فقد طرح الشيخ الأنصاري في “الرسائل” بحث الأصول العملية بهذا الترتيب: للإنسان حالات مختلفة: أحيانًا يكون لديه قطع، وأحيانًا ظن، وأحيانًا شك. صوَّر ثلاث حالات للمكلف. ثم بيَّن لكل حالة من هذه الحالات الثلاث مسائل. ثم وضع الأصول العملية الأربعة في هذه المجاري. هذه المجاري تعرضت للنقد، هل هذه التقسيمات صحيحة أم لا؟ وقُدمت بيانات بديلة لبيان الشيخ الأنصاري.
مقدمات البحث
قبل أن ندخل في الأصول العملية نفسها، نذكر ابتداءً عدة مسائل كمقدمات:
المقدمة الأولى: هذا الاصطلاح، متى ظهر؟ منذ متى دخل هذا الاصطلاح في كتبنا العلمية؟
المقدمة الثانية: تتعلق بتاريخ وتطور الأصول العملية.
المقدمة الثالثة: هل بحث الأصول العملية يُعتبر من مسائل علم الأصول أم لا؟ لأننا وضعنا ضابطة للمسألة الأصولية؛ قلنا إن المسألة تُعتبر من مسائل علم الأصول إذا كان لها هذه الضابطة. نريد أن نرى، أولاً، ما هي تلك الضابطة؟ وهل هي قابلة للتطبيق في مباحث الأصول العملية أم لا؟
المقدمة الرابعة: ما هي العلاقة بين الأصول العملية والأمارات؟ هل الأصول العملية والأمارات في عرض بعضهما أم في طول بعضهما؟ لأن بعض العبارات تشير إلى أن الأصول العملية عند المتقدمين كانت في عرض الكتاب والسنة. نستخدم اصطلاح الأصول العملية بتسامح، فما هي العلاقة بين الأصول العملية والأمارات؟ وما هو سبب تقدمها؟ هذه مسائل يجب مناقشتها اجمالاً.
المقدمة الأولى
بلا شك، اصطلاح “الأصل العملي” بهذا العنوان لم يكن موجودًا في كلمات وعبارات الفقهاء والأصوليين المتقدمين. ربما يمكننا أن نستشف من بعض تعابير المحقق الحلي، صاحب “شرائع الإسلام”، إشارات إلى “الأصل” أو “الأصل العملي”. يقول: «الاجتهاد في العمل بدلالة الأصل ودلالة الاحتياط وغير ذلك». قد يكون هذا مشيرًا إلى الأصل العملي؟ لكنه لا يحتوي على تعبير “الأصل العملي”.
يبدو أن أول من استخدم تعبير الأصل العملي هو الملا أحمد النراقي، كما استخدمه صاحب “هداية المسترشدين”. أي أن هذا اصطلاح ليس قديمًا. على سبيل المثال، في زمن الشيخ الطوسي والسيد المرتضى والشيخ المفيد، لم يكن اصطلاح الأصل العملي موجودًا. نعم، كلمة “أصل” استخدمت في كلماتهم، لكن ليس بمعنى الأصل العملي. كانت لها عدة استعمالات ومعانٍ.
أحيانًا كانوا يستخدمون “الأصل” في بحث القياس؛ يُشار إلى المقيس والمقيس عليه بـ”الفرع” و”الأصل”. الشهيد الثاني استخدم كلمة الاستصحاب أو الأصل بدلاً من المقيس عليه، وكذلك غيره. لذا، أحيانًا استُخدمت كلمة الأصل، لكن بمعنى أحد أركان القياس الثلاثة.
أحيانًا كان المقصود من الأصل أعم من الأصل العملي.
أحيانًا قالوا الأصل وأرادوا منه، على سبيل المثال، البراءة أو الاحتياط تحديدًا. لذا، اصطلاح الأصل العملي لم يُستخدم في كلمات المتقدمين.
لكن الأهم من وجود اصطلاح الأصل العملي في كلمات المتقدمين أو عدمه هو: هل يمكننا أن نجد أثرًا لجوهر الأصل العملي في عبارات الفقهاء والأصوليين المتقدمين؟ أو إذا أشاروا إلى شيء ما بمناسبة، هل كان من حيث المحتوى هو نفسه، ولكن بأي تعبير أشاروا إليه؟ هذا مهم جدًا.
ما يُقال اليوم بشكل واضح عن مجاري الأصول العملية، بالتأكيد لم يكن موجودًا بهذا الشكل في الماضي. هذا طبيعي أيضًا؛ العلوم تتكامل مع مرور الزمن. على سبيل المثال، قد نجد في كلمات السابقين إشارات إلى البراءة، والاستصحاب، والاحتياط، لكن شيئًا مثل أصل التخيير قلما يُرى في عباراتهم.
الشهيد الصدر، في بداية هذا البحث، قدم عرضًا قصيرًا نسبيًا؛ وهو مفيد. طرح ادعاءات يبدو أن بعضها يحتاج إلى تأمل.
أهمية معرفة تاريخ الأصول العملية عند الشيعة، وكيف كانت عند العامة وما هو تصوّرهم عنها، هي مسائل جديرة بالاهتمام، وسنتناولها إن شاء الله.