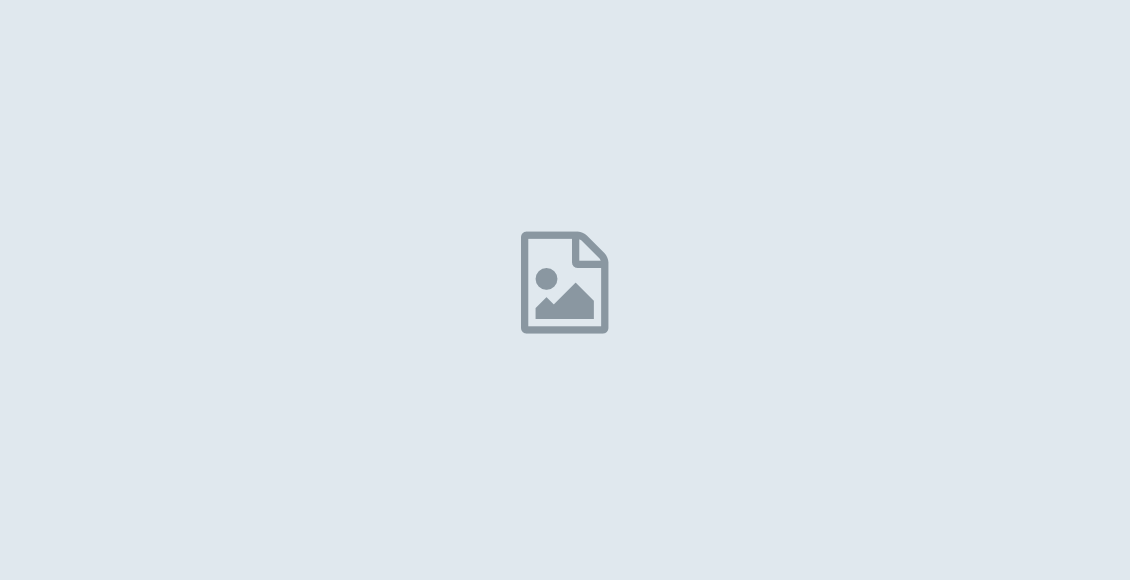أقسام ثلاثية العلم ووجوب الالتفات إلى العلم النافع – المسألة ٤ – مقامان في المناقشة – كلام السيد
الجلسة الأولى
أقسام ثلاثية العلم ووجوب الالتفات إلى العلم النافع
في بداية الدروس في السنة الدراسية الحالية، وفقاً للطريقة المعتادة وتمنّياً وتبرّكاً، ننقل رواية لتكون إن شاء الله نافعة ومفيدة لنا، وكأنّها مصباح مشع ينير طريق مسيرتنا العلمية. الرواية من الإمام الكاظم (ع) التي نقلت في أعلام الدين؛ إذ يقول: «أَوْلَى الْعِلْمِ بِكَ مَا لَا يَصْلُحُ لَكَ الْعَمَلُ إِلَّا بِهِ»، أفضل العلم وأجدره بك ما لا يصلح لك العمل إلاّ به؛ أي العلم الذي يُصلح العمل ويؤثّر فيه. «وَ أَوْجَبُ الْعَمَلِ عَلَيْكَ مَا أَنْتَ مَسْئُولٌ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ»، أوجب العمل عليك ما تُسأل عن العمل به؛ أي العمل الذي يُحاسب عليه. كأنّ عمل الإنسان نوعان: نوع لا يُحاسب عليه، ونوع يُحاسب عليه. بيّن أنّ العمل الذي يُحاسب عليه هو أوجب العمل؛ لا يمكن للإنسان أن يكون غافلاً عنه. «وَ أَلْزَمُ الْعِلْمِ لَكَ مَا دَلَّكَ عَلَى صَلَاحِ قَلْبِكَ وَ أَظْهَرَ لَكَ فَسَادَهُ»، ألزم العلم لك ما دَلَّكَ على صلاح قلبك وأظهر لك فساده؛ أي العلم الذي يُصلح قلبك. هذا يدلّ على أنّ هناك فئة من العلوم لها قيمة وشرف؛ الوعي والمعرفة شرف عام، لكنّ ألزم العلوم هو ذلك العلم الذي يُصلح قلب الإنسان وروحه ونفسه ويُظهر فساده؛ يُظهر صلاح وفساد قلب الإنسان. إذا دلّ العلم على صلاح وفساد الإنسان، فهو بيّن ألزم المعارف. «وَ أَحْمَدُ الْعِلْمِ عَاقِبَةً مَا زَادَ فِي عَمَلِكَ الْعَاجِلِ»، أحمد العلم عاقبة ما زاد في عملك العاجل؛ أي العمل المتعلّق بهذا العالم. إذا زاد العلم في عملك، فهو أحمد العلم. فالإمام الكاظم (ع) في هذه الفقرة من الرواية تحدّث عن أجدر العلوم، وعن ألزمها، وعن أحمدها. كما تحدّث عن أوجب العمل.
هذه مقدمة للنتيجة التي يقول فيها الحضورة: «فَلَا تَشْتَغِلَنَّ بِعِلْمِ مَا لَا يَضُرُّكَ جَهْلُهُ وَ لَا تَغْفُلَنَّ عَنْ عِلْمِ مَا يَزِيدُ فِي جَهْلِكَ تَرْكُه»، فلا تشغل نفسك بعلم لا يضرّك جهله؛ أي لا يُسبّب لك الجهل به ضرّاً. كما احذر من العلم الذي يزيد تركه في جهلك. لا تشغل نفسك بعلم غير نافع، ولا تتّخذ خطوة لتعلم علم يزيد في جهلك.
السؤال الآن هو: كيف يمكن للعلم أن يزيد في جهل الإنسان؟ من كلام الإمام الكاظم (ع) يُستفاد أنّ العلوم ثلاثة أقسام: علوم نافعة، وعلوم ضارّة، وعلوم محايدة.
بعض العلوم ضارّة؛ هذا موضع بحث أنّ العلم كيف يمكن أن يكون ضارّاً. المعرفة تُخرج الإنسان من الجهل؛ فكيف يبقى الإنسان جاهلاً وهو يخرج من الجهل؟ بعض العلوم في ذاتها وجوهرها لا ضرر فيها، لكنّها ضارّة لبعض الناس؛ هذا باب يحتاج إلى بحث، أنّ العلم أحياناً نافع لذاته، لكنّه في الوعاء الذي يُصبّ فيه يتحوّل إلى سمّ. عندما تُصبّ أفضل طعام وأفضل دواء وشافٍ في وعاء غير صحيح، يفسد سريعاً؛ بعض العلوم غير ضارّة لذاتها، لكنّها في بعض الوعاء تتحوّل إلى شيء يُسبّب الضرر. القدرة على الاستيعاب للبعض من المعارف مهمّة؛ أنّك ترى الأئمّة (ع) في بيان المعارف يحرصون على التصنيف، ولا يقولون بعض المواضيع العميقة لبعض أصحابهم، لخوفهم أنّ هذا الموضوع يُسبّب انحرافاً وضلالاً لهم. الالتزام بالتصنيف في بيان المعارف من أهل البيت (ع) لأصحابهم كان قاعدة؛ مثلاً، مواجهة الإمام الصادق (ع) لمحمّد بن مسلم أو زرارة وبعض الآخرين تختلف كثيراً.
بعض العلوم ضارّة لذاتها، بغض النظر عن الوعاء الذي تُصبّ فيه؛ يجب الاجتناب عن كلّيْنِ هذين. العلم الذي يُسبّب جهلاً بالحقيقة وبُعداً عن مبدأ هذا العالم، والعلم الذي يُضرّ بحال الشخص نفسه وغيره ولا يُنتج إلاّ الضرر، هذا علم ضارّ.
بعض العلوم محايدة؛ تلك التي قال عنها الإمام الكاظم (ع): جهلها لا يُسبّب ضرّاً للإنسان. بلى! أحياناً معرفة هذه العلوم فضيلة؛ لكنّ في زمن الأمر بين اكتساب المعارف والوعيات الّتي هي لازمة للإنسان والوعيات الّتي لا لازميّتها وجهلها لا يُسبّب ضرّاً، بالتأكيد يجب أن يُصْرَف وقت الإنسان للوعيات من النوع الأوّل. اليوم كلّنا مصابون باستخدام الفضاء الافتراضي واكتساب وعيات بعضها ضارّ أيضاً. لا أريد القول إنّ كلّ محتويات الفضاء الافتراضي هكذا؛ أنّ الإنسان يعرف أحوال وأحداث محيطه، هذا أمر لازم ويجب أن يكون كذلك؛ لكنّ أنّ الإنسان بدلاً من الالتفات إلى العلم اللازم النافع، يُصْرِف وقته في التجوال والتسرّب في الفضاء الافتراضي، ولو لم يترتّب عليه مفسدة، فهو منهيّ عنه. هذا في حال أنّ لدينا موادّ ومسائل كثيرة لازم أن نعرفها لصلاح أنفسنا ومجتمعنا؛ للوقاية من فساد أنفسنا ومجتمعنا.
هذا الطريق الّذي نحن فيه، أي طلب العلوم الإسلاميّة والدّينيّة، هذه المسؤوليّة الّتي وُضِعَتْ على كاهلنا، العلوم الّتي نطلبها في الحوزات، بغض النظر عن ترتيب العلوم وأولويّاتها، في الجملة من العلوم الّتي لها قدرة على إفادة الإنسان والمجتمع. هذا لا يعني أنّ كلّ من تعلّم هذه العلوم يصبح بالضرورة شخصاً نافعاً. إذا صُبَّ هذا العلم في وعاء غير صحيح، يصبح حجاباً والضرُّ منه أشدُّ ممّن لا علم لهم. قدّم الله لنا هذه التوفيق وبَرَمَجَ لنا هذا البستر لنتعلم العلم النافع؛ لكنّنا مع التعلم نُوَفِّر المقتضى في أنفسنا، لكنّنا يجب أن نُزِيل العوائق أيضاً. هذه العلوم ألزم العلوم وأجدرها؛ أحمد العلوم؛ لأنّها علوم تُظْهِر صلاحنا وفسادنا. ما أفضل من أنّنا نتعلم شيئاً يذهب به جانّا وروحنا نحو الصلاح والارتقاء والتقدُّم والتكامل ويمنع سقوطه؟ هذا العلم النافع. قدّم الله هذه التوفيق والبستر لنا، لكنّنا للأسف لا نعرف قيمة هذه الفرصة والنعمة؛ أقصد نفسي بالذّات. الآن في الدرس القادم، سأقول رواية عن الفرصة أنّ كيف يُسبّب ضياع الفرص نَدَمَةً وأسفاً. في النهاية، تمرّ هذه الأيّام والأوقات؛ لكنّ لا يأتِ زمن – لا قدر الله – نَأْسَفُ فيه لِمَ لم نستغلّ فرصة الشّباب والصِّحَّة والعافية وشغلنا بأشياء فاسدة أو لا صلاح وفساد فينا؟ لِمَ لا نُصْرِف وقتنا وطاقتنا لهذه العلوم؟ بالطبع المشكلات والمتاعب كثيرة؛ هذه كلُّها في مكانها، لكنّ هذه المسؤوليّة – سواء فرديّة أو اجتماعيّة – ثقيلة علينا جداً. يُؤَوِّلُ الله إن شاء الله ببركة الأولياء المعصومين (ع)، ببركة أنفاس قدسيّة أمضَوْا عمرهم في هذه الحوزات ونحن جالسون على مائدة واسعة من جهود ومساعي مئات السنين، يُؤَوِّلُ لنا توفيق الاستفادة من هذه الفرصة. ما نستفيده اليوم هو ثمرة التضحيات والجهود والكفاحات لعلماء كبار في ظروف قاسية ومُثِيرَة للشَّفَقَة، في أوقات الخَطَرَاتِ والتهديدات الجسديّة والماليّة، لم يتركوا هذه الرّسالة الجليلة وأبْقَوْا هذا المِشْعَلَ مشعّاً إلى اليوم. هذا يجب أن يُنَبِّهَنا إلى هذه المسؤوليّة. نسأل الله أن يُؤَوِّلَ لنا في بداية هذه السنة الدراسيّة توفيق الاستفادة الأكثر من هذه الدروس والمناقشات، وأنْ تظْهَرَ آثارها في عملنا وتكون مؤثِّرَة؛ نعرف الصلاح والفساد ونطبِّقَهُ في الحياة. إن شاء الله لا نُخْيِبْ أمَلَ الوجود المقدَّس لبقيَّة الله الأعظم (عج)؛ على الأقلّ إذا لم نُحْدِثْ فخراً، لا نكون – لا قدر الله – سبباً للعار والخزي. نأخذ رضا ذلك الحضرة ورضاه في الاعتبار ونرى حقّاً ما الذي يمكن أنْ يُسَرِّيَ خاطرَ ذلك الوجود الشَّرِيفِ؛ إذا خَذَلْنَا في هذا الطريق خطوة صغيرة وحركة هزيلة، فكونوا مطمئنين أنَّ لطائفَهُ وعنايَتَهُ ودعواتَهُ ستشملُنا بأضعاف مُضَاعَفَة.
إشارة إلى المناقشة السابقة
كانت مناقشتنا في «فصل في أولياء العقد»؛ قرأنا ثلاث مسائل. آخر مسألة ناقشناها السنة الماضية كانت في شأن ولايَةِ الأبِ والجدِّ بالنِّسبَةِ إلى تزويجِ البِكْرِ الرَّشِيدَةِ؛ ناقشناها بالتَّفْصِيلِ. أولياءُ العقدِ أي الَّذِينَ لهم ولايَةٌ بِالنِّسْبَةِ إلى عَقْدِ النِّكَاحِ؛ الأوَّلُ منهم الأبُ والجَدُّ. قُلْنَا بِالنِّسْبَةِ إلى مَنْ لَهُمْ ولايَةٌ وَبِالنِّسْبَةِ إلى مَنْ لا وَلايَةَ لَهُمْ، حَتَّى وَصَلَتِ الْمُنَاقَشَةُ إلى الْبَالِغَةِ الرَّشِيدَةِ. فِي الْمَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ يَتَكَلَّمُ عَنْ شَرْطِ وَلايَةِ الأَبِ وَالْجَدِّ بِالنِّسْبَةِ إلى الَّذِينَ يُعَدُّونَ مَوْلًى عَلَيْهِمْ، سَوَاءٌ كَانُوا بَالِغَاتٍ رَشِيدَاتٍ أَوْ صِغَارًا.
المسألة ٤
«يَشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ تَزْوِيجِ الأَبِ وَالْجَدِّ وَنُفُوذِهِ عَدَمُ الْمُفْسِدَةِ». فِي صِحَّةِ تَزْوِيجِ الأَبِ وَالْجَدِّ، يَشْتَرَطُ أَلَّا تَتْرَتَّبَ عَلَيْهِ مُفْسِدَةٌ؛ صِحَّةُ وَنُفُوذُ تَزْوِيجِ الأَبِ وَالْجَدِّ أَوْ بِالتَّعْبِيرِ الْآخَرِ وَلايَتُهُمَا، مُشْرُوطَةٌ إلى عَدَمِ الْمُفْسِدَةِ. ذَلِكَ الْعَقْدُ الَّذِي يُعْقِدُهُ الأَبُ أَوْ الْجَدُّ، لا يَكُونُ لَهُ مُفْسِدَةٌ عَلَى الْمَوْلَى عَلَيْهِ. «وَإِلَّا يَكُونُ الْعَقْدُ فَضُولِيًّا كَالْأَجْنَبِيِّ يَتَوَقَّفُ صِحَّتُهُ عَلَى إِجَازَةِ الصَّغِيرِ بَعْدَ الْبُلُوغِ»، إِذَا عَقَدَ الأَبُ الْعَقْدَ لِلْبِكْرِ الرَّشِيدَةِ أَوْ حَتَّى الصَّغِيرَةِ وَكَانَتْ لَهُ مُفْسِدَةٌ، فَهَذَا الْعَقْدُ فَضُولِيٌّ؛ مِثْلَ أَنْ يَعْقِدَ الْأَجْنَبِيَّ لِغَيْرِهِ. الْعَقْدُ لِبِنْتٍ مِنْ نَاحِيَةِ الْأَجْنَبِيِّ، مَرْعِيٌّ بِإِجَازَةِ تِلْكَ الْبِنْتِ. مَثَلًا، إِذَا عَقَدَ الأَبُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ وَفِي حَالِ الْمُفْسِدَةِ، لِلصَّغِيرِ، فَهَذَا مَرْعِيٌّ حَتَّى يَبْلُغَ هَذَا الصَّغِيرُ ثُمَّ يُؤَذَّنَ. «بَلِ الْأَحْوَطُ مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ»، الْأَحْيَاطُ الْوَاجِبُ أَنْ تُرَاعَى الْمَصْلَحَةُ.
فِي الْحَقِيقَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَتَكَلَّمُ عَنْ اشْتِرَاطِ أَمْرَيْنِ؛ الْإِمَامُ تَبَعًا لِصَاحِبِ الْعُرْوَةِ وَغَيْرِهِ، تَكَلَّمَ عَنْ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ. الشَّرْطُ الأَوَّلُ أَنَّ وَلايَةَ الأَبِ وَالْجَدِّ فِي أَمْرِ النِّكَاحِ وَعَقْدِ الزَّوَاجِ مُشْرُوطَةٌ إلى عَدَمِ الْمُفْسِدَةِ أَمْ لا؟ لِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ نُنَاقِشَ أَنَّ عَدَمَ الْمُفْسِدَةِ فِي صِحَّةِ وَنُفُوذِ عَقْدِ الأَبِ وَالْجَدِّ مَعْتَبَرٌ أَمْ لا. فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ، الْكَلَامُ فِي أَنَّ الْمَصْلَحَةَ مَعْتَبَرَةٌ أَمْ لا؟ وُجُودُ الْمَصْلَحَةِ غَيْرُ عَدَمِ الْمُفْسِدَةِ؛ أَحْيَانًا نَقُولُ الْعَقْدُ لا مُفْسِدَةَ لِلْبِنْتِ؛ عَدَمُ الْمُفْسِدَةِ أَعَمُّ مِنْ وُجُودِ الْمَصْلَحَةِ أَوْ عَدَمِهَا. يُجْرِي عَقْدًا وَيُزَوِّجُ بِهِ شَخْصًا لِبِنْتِهِ لا مَصْلَحَةَ فِيهِ وَلَكِنْ لا مُفْسِدَةَ أَيْضًا. دَرَجَةٌ أَعْلَى هِيَ أَنْ لا مُفْسِدَةَ فَقَطْ بَلْ مَصْلَحَةَ أَيْضًا؛ أَيْ مَصْلَحَةٌ فِي هَذَا الْعَقْدِ. مَثَلًا هَذَا الشَّخْصُ الَّذِي أَزْوَجَ بِنْتَهُ بِهِ، صَاحِبُ شَرَفٍ عَائِلِيٍّ، وَلَدَيْهِ كَفَايَةٌ مَالِيَّةٌ، وَعَمَلٌ جَيِّدٌ، وَأَخْلَاقٌ حَسَنَةٌ.
مقامان في المناقشة
فَنَحْنُ هُنَا يَجِبُ أَنْ نُنَاقِشَ فِي مَقَامَيْنِ: ١. اعْتِبَارُ عَدَمِ الْمُفْسِدَةِ؛ ٢. اعْتِبَارُ الْمَصْلَحَةِ. الْإِمَامُ (رَحْمَهُ اللَّهُ) فِي الْمَقَامِ الأَوَّلِ، فَتْوَى بِالِاشْتِرَاطِ؛ أَيْ يَقُولُ عَدَمُ الْمُفْسِدَةِ مَعْتَبَرٌ؛ وَطْبَعًا فِي ذِيلِهِ رَفَعَ هَذَا الْبَحْثَ أَنَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا الشَّرْطُ، فَالْعَقْدُ مِثْلُ عَقْدِ الْأَجْنَبِيِّ وَالْفَضُولِيِّ الَّذِي صِحَّتُهُ مَرْعِيَّةٌ وَمُعَلَّقَةٌ عَلَى الْإِذْنِ. فِي شَأْنِ الشَّرْطِ الثَّانِي، أَحْيَطَ وَجُوبِيًّا وَلَمْ يُفْتِ. فَيَجِبُ أَنْ نَرَى دَلِيلَ اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْمُفْسِدَةِ مَا هُوَ؟ وَالْآخَرُ أَنْ نَرَى هَلْ أَصْلًا الْمَصْلَحَةُ شَرْطٌ أَمْ لا؟ هَلْ وُجُودُ الْمَصْلَحَةِ لَازِمٌ أَمْ لا؟ هُنَا لِمَاذَا أَحْيَطَ الْإِمَامُ وَجُوبِيًّا؟ هَذَانِ الْمَقَامَانِ اللَّذَانِ يَجِبُ أَنْ نُنَاقِشَهُمَا فِي اسْتِمْرَارِ الْمُنَاقَشَةِ.
كلام السيد
لأَنَّنَا عَادَةً كُنَّا نَقْرَأُ نَصَّ الْعُرْوَةِ أَيْضًا، فَأَقْرَأُ نَصَّ الْعُرْوَةِ بِسُرْعَةٍ. صَاحِبُ الْعُرْوَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْخَامِسَةِ مَسَّ هَذَا الْمَوْضُوعَ: «يَشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ تَزْوِيجِ الأَبِ وَالْجَدِّ وَنُفُوذِهِ عَدَمُ الْمُفْسِدَةِ وَأَلَّا يَكُونَ الْعَقْدُ فَضُولِيًّا كَالْأَجْنَبِيِّ»، إِلَى هُنَا مِثْلُ نَصِّ التَّحْرِيرِ؛ يَقُولُ: لِصِحَّةِ وَنُفُوذِ تَزْوِيجِ الأَبِ وَالْجَدِّ، يَشْتَرَطُ أَلَّا تَكُونَ فِي النِّكَاحِ مُفْسِدَةٌ؛ وَإِلَّا صَارَ الْعَقْدُ فَضُولِيًّا، مِثْلَ الْعَقْدِ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْأَجْنَبِيُّ. هُنَا لَدَى الْمَرْحُومِ السَّيِّدِ إِضَافَةٌ لَيْسَتْ فِي نَصِّ التَّحْرِيرِ؛ يَقُولُ: «وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ الصِّحَّةِ بِالْإِجَازَةِ أَيْضًا». الْمَرْحُومُ السَّيِّدُ رَفَعَ هُنَا احْتِمَالًا وَهُوَ أَنَّ إِذَا كَانَتْ مُفْسِدَةٌ، فَهَذَا الْعَقْدُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَلا يَصِيرُ صَحِيحًا بِالْإِذْنِ أَيْضًا؛ أَيْ لا يَصِيرُ فَضُولِيًّا أَيْضًا. نَفْسُ الْإِمَامِ (رَحْمَهُ اللَّهُ) فِي ذِيلِ هَذِهِ الْفَقْرَةِ مِنْ نَصِّ الْعُرْوَةِ حَاشِيَةٌ: «لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ»؛ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الِاحْتِمَالَ ضَعِيفٌ؛ لِذَلِكَ لَمْ يَأْتِ بِهِ فِي نَصِّ التَّحْرِيرِ. غَيْرُهُمْ أَيْضًا أَشْكَلُوا عَلَى الْمَرْحُومِ السَّيِّدِ فِي هَذَا الِاحْتِمَالِ؛ الْمَرْحُومُ الْمُحَقِّقُ الْعِرَاقِيُّ، الْمَرْحُومُ الْمُحَقِّقُ النَّائِينِيُّ، هَؤُلَاءِ أَيْضًا أَشْكَلُوا عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ لِلْمَرْحُومِ السَّيِّدِ. نَصُّ الْمَرْحُومِ النَّائِينِيِّ هُوَ: «الْأَقْوَى كِفَايَةُ الْإِجَازَةِ بَعْدَ الْبُلُوغِ». تَعْبِيرُ الْمُحَقِّقِ الْعِرَاقِيِّ مِثْلُ الْمَرْحُومِ الْإِمَامِ وَكَتَبَ: «وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا»، هَذَا الِاحْتِمَالُ جِدًّا ضَعِيفٌ. أَيْ فِي الْحَقِيقَةِ اعْتِرَاضٌ عَلَى الْمَرْحُومِ السَّيِّدِ أَنَّ لِمَاذَا ذَكَرَ هَذَا الِاحْتِمَالَ. الْمَرْحُومُ السَّيِّدُ الْخُوَائِيُّ أَيْضًا فِي شَأْنِ هَذَا الِاحْتِمَالِ أَشْكَلَ وَقَالَ: «لَكِنَّهُ بَعِيدٌ وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ».
بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ الْمَرْحُومُ السَّيِّدُ: «بَلِ الْأَحْوَطُ مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ»، الْأَحْوَطُ أَنْ تُرَاعَى الْمَصْلَحَةُ. أَيْ أَعْلَى مِنْ عَدَمِ الْمُفْسِدَةِ. لَيْسَ أَنَّهُمَا شَرْطَانِ؛ طَبْعًا مَنْ يَقُولُ الْمَصْلَحَةُ مَعْتَبَرَةٌ، فَقَدْ أَدْخَلَ عَدَمَ الْمُفْسِدَةِ أَيْضًا. وَلَكِنْ بَعْضُهُمْ بَقِيَ فِي الْمَرْحَلَةِ الأُولَى وَبَعْضُهُمْ يَقُولُونَ أَعْلَى مِنْ هَذَا الْمَصْلَحَةُ لَازِمَةٌ أَيْضًا. «بَلْ يَشْكُلُ الصِّحَّةُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ خَاطِبَانِ أَحَدُهُمَا أَصْلَحُ مِنَ الْآخَرِ بِحَسْبِ الشَّرَفِ أَوْ مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الْمَهْرِ أَوْ قِلَّتِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصَّغِيرِ فَاخْتَارَ الأَبُ غَيْرَ الْأَصْلَحِ لِتَشْهِيِّ نَفْسِهِ»؛ الْمَرْحُومُ السَّيِّدُ يَقُولُ إِذَا جَاءَ اثْنَانِ مِنَ الْخَوَاطِبِ لِنِكَاحِ الْبِنْتِ، وَلَكِنْ أَحَدُهُمَا أَصْلَحُ مِنَ الْآخَرِ، الْآنَ إِمَّا بِحَسْبِ الشَّرَفِ الْعَائِلِيِّ أَوْ كَثْرَةِ الْمَهْرِ أَوْ أَشْيَاءَ مُشَابِهَةٍ، وَلَكِنَّ الأَبَ لِإِرْضَاءِ رَغْبَةِ نَفْسِهِ اخْتَارَ الْآخَرَ وَتَجَاهَلَ مَصْلَحَةَ الْبِنْتِ، فَهَذَا الْعَقْدُ غَيْرُ صَحِيحٍ.
الْيَوْمَ بَيَّنْتُ وَجْهَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّنَا يَجِبُ أَنْ نُنَاقِشَ فِي مَقَامَيْنِ: ١. اعْتِبَارُ عَدَمِ الْمُفْسِدَةِ؛ ٢. اعْتِبَارُ الْمَصْلَحَةِ.