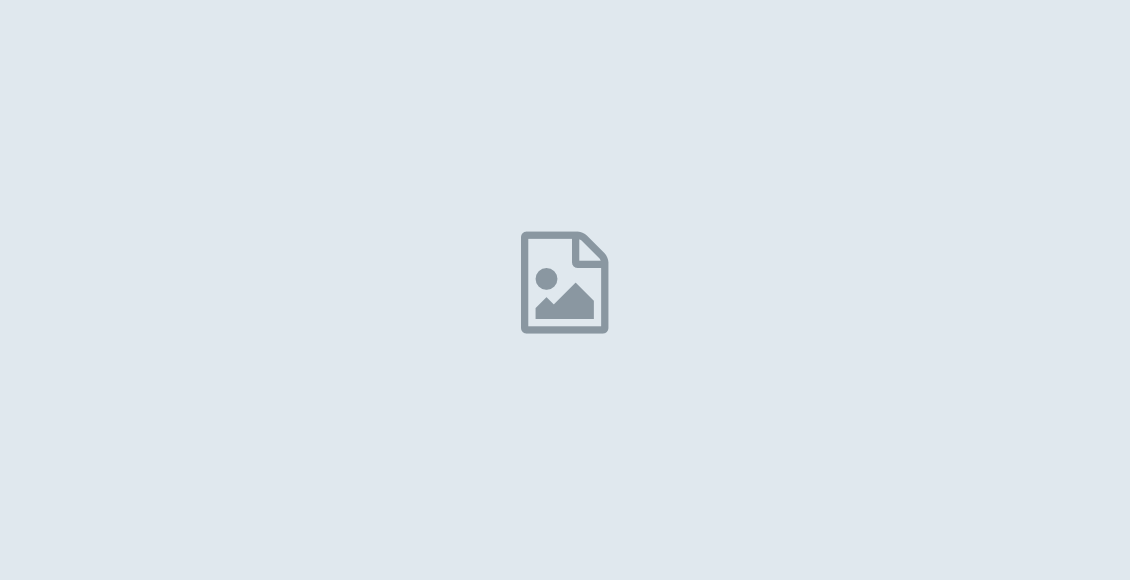الجلسة الأولى
أقسام القطع – القطع الطريقي والموضوعي – أقسام القطع الموضوعي
التاريخ: 8/6/1444 هـ
تقوى الله في الخلوات
في بداية مناقشة أصول الفقه، ننقل تيمّنًا وتبركًا رواية عن أمير المؤمنين علي (ع)، راجين أن تزيدنا هذه الكلمات النورانية توفيقًا، وأن تمنح حياتنا العلمية بركة أكثر، إن شاء الله.
يقول الإمام علي (ع): «اتَّقُوا مَعَاصِيَ اللهِ فِي الخَلَوَاتِ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الحَاكِمُ». اتقوا الله في الخلوات، فإن الذي يشهد هو الحاكم والقاضي.
إن تقوى الله، والتي تعني مراقبة النفس والتحكم فيها، أمرٌ أكد عليه القرآن والروايات مرات عديدة. ليس المقصود بتقوى الله الخوف منه، بل المحافظة على النفس من الوقوع في معصية الله. لكن القيد الذي أضافه أمير المؤمنين هنا هو «في الخلوات». فمراقبة النفس من المعصية والامتناع عن الذنوب قد يكون أحيانًا علنيًا وأحيانًا خفيًا. والمحافظة على النفس من الذنوب في العلن ليست بصعوبة المحافظة عليها في الخفاء. خاصة بالنسبة لأمثالنا، فنحن نمتنع عن الذنب العلني، إلا إذا كان الشخص متهاونًا جدًا. لكن في الخفاء، فإن مراقبة النفس صعبة جدًا، أي في المواقف التي لا يوجد فيها شاهد أو ناظر، حيث تتضاعف الوساوس بشكل كبير. بالنسبة لنا، الذين نحرص على تجنب الفضيحة أمام الناس ونخشى أن يسيء الناس الظن بنا أو أن نقع من قدرنا ومكانتنا لديهم، فإن الذنب في الخفاء لا يترتب عليه هذه المخاوف. يقول أمير المؤمنين (ع): «اتَّقُوا مَعَاصِيَ اللهِ فِي الخَلَوَاتِ»، وهذا أمر بالغ الأهمية. إذا تمكنا في الخلوات، حيث لا يوجد شاهد، من الامتناع عن الذنب وحفظ أنفسنا منه، فهذه مرتبة عالية من تقوى الله. غالبًا ما تكون فرص الانزلاق إلى الذنب موجودة في الخلوات، حيث يكون الإنسان وحيدًا بلا ناظر أو حاضر، ويزول الحياء والخجل الذي يكون موجودًا في حضور الآخرين، مما يزيد من فرص الانزلاق إلى الذنب.
ثم يذكر أمير المؤمنين تعليلًا لطيفًا جدًا: «فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الحَاكِمُ». اتقوا الذنوب في الخلوات لأن الشاهد هو نفسه الحاكم.
أولًا: تعبير «فإن الشاهد» يشير إلى أنك قد تعتقد أنك في خلوة، لكنك لست كذلك، فهناك ناظر يرى. يجب أن نؤمن بهذا. إذا أدرك الإنسان في أشد الخلوات أن هناك ناظرًا يراه، فهذا يغير الأمر كثيرًا. فكما أن الإنسان لا يقدم على أفعال معينة أمام ناظر، فإن الله، الذي هو أحضر الحاضرين وأنظَر الناظرين، هو الشاهد الأعظم. إذا آمنا أن الله شاهد، فهذا بحد ذاته يمكن أن يكون مؤثرًا جدًا. إذًا، ما تظنه خلوة ليس خلوة في الحقيقة.
ثانيًا: الشاهد هو نفسه الحاكم. عندما تُعقد محكمة العدل الإلهي، «مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ» و«مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ»؛ فإن أصغر الذنوب تظهر ويُسأل عنها ويُحاسب عليها. في محاكم الدنيا، يُطلب من الشاهد أن يأتي ويشهد على الخير أو الشر، لكن في الآخرة لا حاجة للشهود، فأعضاء الإنسان وجوارحه هي أفضل الشهود، وأهم من ذلك، الله تبارك وتعالى، القاضي وأحكم الحاكمين، هو نفسه الشاهد.
لذلك، لا يظن أحد أنه إذا ارتكب معصية في الخلوات فلن يترتب عليه شيء، «فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الحَاكِمُ». يجب أن نراقب أنفسنا في الخلوات، حيث لا يوجد ظاهريًا أي ناظر، لكن الله تبارك وتعالى موجود، وهو الشاهد والحاكم. وإذا وقعنا في معصية -لا قدر الله-، يجب أن نتوب ونستغفر، ولا نفكر أن الذنب في الخلوات، حتى لو كان صغيرًا، ينتهي عند هذا الحد. فقد قال الإمام الرضا (ع): «الصَّغَائِرُ مِنَ الذُّنُوبِ طُرُقٌ إِلَى الكَبَائِرِ». الذنوب الصغيرة التي قد تبدو تافهة بالنسبة لنا، قد تتحول -لا قدر الله- إلى عادة سيئة إذا أصررنا عليها، مما يفتح الطريق تدريجيًا إلى الذنوب الكبيرة. لماذا؟ لأن الإمام الرضا (ع) يقول: «وَمَنْ لَمْ يَخَفِ اللهَ فِي القَلِيلِ لَمْ يَخَفْهُ فِي الكَثِيرِ». من لا يخشى الله في الذنوب الصغيرة، سيصل تدريجيًا إلى مرحلة لا يخشى فيها الذنوب الكبيرة. أحيانًا يشعر الإنسان أن التوفيق يُسلب منه، ومهما بحث عن السبب قد لا يجده، لكن يجب أن نبحث في هذه الأمور، ونتتبع ما إذا كنا أصررنا على ذنب صغير أدى تدريجيًا إلى الذنوب الكبيرة.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمراقبة أنفسنا أمام هوى النفس، والذنوب الكبيرة والصغيرة، علنًا وخفاءً، حتى لا نقع في الزلل، وأن تزداد توفيقاتنا يومًا بعد يوم، إن شاء الله.
أقسام القطع
تناولنا في مناقشتنا، بعد الحديث عن مسائل التجري، أقسام القطع. تحدث الشيخ الأنصاري عن القطع وأقسامه، وقال في “الرسائل” إن القطع ينقسم إلى قسمين: القطع الطريقي والقطع الموضوعي. المناقشات التي تناولناها حتى الآن عن القطع كانت تتعلق بالقطع الطريقي. لكن هناك قسم آخر من القطع، وهو القطع الموضوعي. كما أشار المحقق الخراساني في “الكفاية” إلى مسائل تتعلق بالقطع الموضوعي والطريقي. سنقدم شرحًا موجزًا عن هذه الأقسام، ثم ننتقل إلى مناقشة بعض الآراء حول إمكانية أو استحالة بعض هذه الأقسام.
1. القطع الطريقي
معنى القطع الطريقي واضح ولا يحتاج إلى تفسير. القطع الطريقي هو القطع الذي لم يُؤخذ في موضوع الدليل الشرعي. فما هو موضوع الحكم الشرعي هو العنوان الواقعي، مثل «الصلاة واجبة» أو «الخمر حرام». في هذين الدليلين، موضوع الحكم (الوجوب أو الحرمة) هو الخمر الواقعي أو الصلاة الواقعية، والقطع لم يُؤخذ في موضوع الخطاب أو الدليل. إذا افترضنا أن شخصًا أيقن بخمرية سائل ما، فهذا اليقين هو طريق للوصول إلى الواقع، لكنه لا يلعب أي دور في ثبوت الحكم. القطع الطريقي هو القطع الذي يكون طريقًا لمعرفة الواقع، وبعبارة أخرى، لا دور له في الحكم لأنه لم يُؤخذ في موضوع الخطاب.
2. القطع الموضوعي
أما القطع الموضوعي فهو القطع الذي يُؤخذ في موضوع الخطاب أو الدليل الشرعي. ماذا يعني أن يُؤخذ في موضوع الخطاب؟ وكيف يمكن أن يُؤخذ القطع في موضوع خطاب؟ أشار المحقق الخراساني في “الكفاية” إلى أن القطع بحكم لا يمكن أن يُؤخذ في موضوع حكم مماثل لحكمه أو مضاد لحكمه، بل يمكن أن يُؤخذ في موضوع حكم آخر غير حكمه. على سبيل المثال، يمكن أن يقال: «إذا قطعت بوجوب الصلاة يجب عليك التصدق». هنا لا إشكال، لأن القطع بحكم أُخذ كموضوع لحكم آخر غير متعلقه. لكن لا يمكن أن يقال: «إذا قطعت بوجوب الصلاة يجب عليك الصلاة»، لأن القطع بحكم لا يمكن أن يُؤخذ في موضوع حكم مماثل. ولا يمكن أن يقال: «إذا قطعت بوجوب الصلاة يحرم عليك الصلاة»، لأن القطع بحكم لا يمكن أن يُؤخذ في موضوع حكم مضاد. هذا أمر مسلم.
لكن أحيانًا يُؤخذ القطع بموضوع في موضوع الحكم. على سبيل المثال: «إذا قطعت بخمرية شيء يحرم عليك الخمر». هنا، القطع بخمرية الشيء أُخذ كموضوع لهذا الحكم. إذًا، لدينا قطع طريقي وقطع موضوعي.
سؤال:
الأستاذ: ماذا يعني القطع الموضوعي؟ يعني القطع الذي يُؤخذ في الموضوع. هذا القطع قد يكون تارةً قطعًا بموضوع، وأحيانًا قطعًا بحكم. وهذا يرجع إلى اختلاف متعلق القطع، فتارةً يكون متعلق القطع هو الموضوع، وتارةً يكون الحكم.
أقسام القطع الموضوعي
القطع الموضوعي ينقسم بحسب اعتبار إلى قسمين:
التقسيم الأول
- القطع الموضوعي بنحو تمام الموضوع: إذا كان القطع هو كل ملاک موضوع الحكم، بمعنى أن الواقع لا دور له في الحكم، فهذا يسمى قطعًا موضوعيًا بنحو تمام الموضوع. على سبيل المثال: «إذا قطعت بخمرية شيء فهو حرام لك». هنا، كل ملاک الحرمة هو القطع بخمرية الشيء، بغض النظر عما إذا كان الواقع خمرًا أم لا. حتى لو كان الواقع ماءً، فإذا أيقنت بخمريته، فشربه حرام.
- القطع الموضوعي بنحو جزء الموضوع: أحيانًا يُؤخذ القطع كجزء من موضوع الحكم، مثل: «إذا قطعت بخمرية شيء وكان في الواقع خمرًا فهو حرام». هنا، يجب أن يجتمع أمران لثبوت الحرمة: 1) القطع بخمرية الشيء، 2) أن يكون الشيء خمرًا في الواقع. فالقطع بخمرية الشيء وحده لا يكفي، والخمر الواقعي إذا لم يكن مقطوعًا به لا يكفي. هذا هو القطع الموضوعي بنحو جزء الموضوع.
التقسيم الثاني
كل من هذين القسمين ينقسم إلى قسمين آخرين:
- القطع الموضوعي بنحو الصفتية: أي أن يُؤخذ القطع كصفة نفسية للمكلف، أي الحالة النفسية التي تتشكل لديه. إذا أُخذ القطع بهذا الاعتبار، يُسمى قطعًا موضوعيًا بنحو الصفتية.
- القطع الموضوعي بنحو الطريقية: أي أن يُؤخذ القطع كطريق إلى الواقع، أي ككاشف عن الواقع، دون النظر إلى كونه صفة نفسية. هذا ينتج أربعة أقسام، لأن القطع الموضوعي، سواء بنحو تمام الموضوع أو جزء الموضوع، يُؤخذ إما بنحو الصفتية أو بنحو الطريقية.
وفيما يتعلق بالقطع الموضوعي بنحو الطريقية، ذُكر قسمان:
- إذا أُخذ القطع الموضوعي بنحو الطريقية التامة، أي الكاشفية التامة.
- وأحيانًا تُؤخذ الكاشفية بشكل عام دون النظر إلى كونها تامة أم ناقصة. إذا أخذنا هذين القسمين للقطع الموضوعي بنحو الطريقية، فإننا نحصل على خمسة أقسام إجمالًا. هذه هي الأقسام التي ذُكرت للقطع الموضوعي.
إذًا، القطع إما طريقي أو موضوعي. والقطع الموضوعي إما بنحو تمام الموضوع أو جزء الموضوع. وكل منهما إما بنحو الصفتية أو الطريقية. والطريقية إما بنحو الكاشفية التامة أو بشكل عام (تامة أو ناقصة). هذه هي أقسام القطع الموضوعي.
توجد مناقشات حول إمكانية بعض هذه الأقسام أو استحالتها عقلاً.